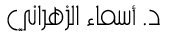|
وحين يخفي المرء عجزه وضعفه خلف قناع من القوة المفتعلة، فهو إنسان مختصر. والإنسان
الضعيف، يحرص على أن يحافظ على الضجيج حوله، لكي ينشغل الآخرون عن ملاحظة سوأته.
هذا ما أفادت به الدكتورة هناء المطلق، في دراستها سيكولوجية الإنسان الخليجي.
وتحيل لفظة الاختصار هنا إلى النقص، والنقص السيكولوجي لدى الإنسان العربي – وليس
الخليجي وحده – ينشأ من عجزه عن مواجهة حقائق الحياة، بما تتطلبه من منطق مجرد، ومن
تلك الحقائق والسنن التي يعجز العربي عن تفهمها، فكرة التعدد كسنة كونية، تحكم كل
شيء، فداخل كل إنسان مثلا، ملامح أنوثة، إلى جانب ملامح الذكورة، تمكن الإنسان من
مواجهة مطالب الحياة، التي تحتاج لكلا الجانبين، لكن الرجل العربي، يظل طول عمره
يجاهد في إخفاء نصفه اللين، لأنه يعده عجزا وضعفا. وتظل المرأة العربية بالمقابل،
تكبت نصف تكوينها النفسي، لأنها تربت على أن الأنوثة هي الضعف والاستكانة، وهو شكل
آخر من الاختصار. يتماشى هذا السلوك، مع ما يسميه الدكتور مصطفى حجازي في كتابه: “الإنسان المقهور”، بالانشطار الانفعالي، أي انشطار الذات إلى داخل وخارج، داخل خير، وخارج شرير. ووفق هذا الانشطار يخشى العربي على سلامة هويته في وجود الآخر، ولذا هو في مواجهة دائمة، مع ذلك الآخر، الذي قد لا يكون سوى نفسه. المثقف يبحث عن الآخر في وسط ثقافي، أو في حضارة أخرى، ليجند كل شيء لمحاربته. والعامي يجد الآخر/ الخطر، في الجن والعفاريت، التي ينسب لها كل شيء يعجز عن تفسيره. وليست العصبيات والحمية القبلية، والطائفية، سوى تجسيد لهذا الانشطار. وينتهي عمر الواحد منا، وهو خائف من آخر، يهدد وجوده، وهويته، فينشغل عن خلق هذه الهوية، وتنميتها، بقمع الآخر الذي يهددها، بشتى أنواع القمع. يحتاج هذا الإنسان المختصر ـ إذن ـ أن يقمع الآخر الذي يذكره بضعفه، المرأة بالنسبة للرجل، والطفل بالنسبة للمرأة، والمرؤوس للرئيس،… إلخ السلسلة، يقمعه ليواري ضعفه المتجسد فيه. ولعل الكواكبي كان يدرك هذا الخلل المتجذر في الوعي العربي، حين وضع كتابه: “طبائع الاستبداد “، وهو يعرف الاستبداد بأنه ” تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا خوف تبعة”. وأيضا “غرور المرء برأيه والأنفة من قبول النصيحة، أو الاستقلال بالرأي في الحقوق المشتركة”، وكأنه لمس الوضع القائم في مؤسساتنا، الصغرى والكبرى، فقد دخلنا الحضارة الحديثة، حاملين معنا فخر عنترة، وضغينة كليب، حتى إننا وظفنا التقنية لتغذية هذه العصبيات، وشتى صور الانشطار الانفعالي. وكما قال الراحل، عبدالرحمن منيف، عن هرمية الاستبداد في المجتمع العربي، كيف أن العربي إذا لم يجد من يتسلط عليه، تسلط على الطبيعة، فشوهها ولوثها، وهكذا يفعل بعض الصغار بجدران مدارسهم، وقد تكون مدينة بأسرها جدارا لأحدهم، يتسلى بشخبطته. وهذا القمع للآخر يتضمن نوعا من التدجين المزدوج للشخصية، فالاستبداد فعل يحتاج لفاعل ولمفعول به، وهكذا يتم تعليم الطفل سلطاته، بقدر ما يتم تعليمه لمن يخضع، تماما بهذا التناقض الرهيب، الذي يعزز نوعا آخر من الانشطار الانفعالي، ينقسم الفرد فيه إلى خاضع ومستبد، وهو بقدر ما يخضع، يعوض بممارسة الاستبداد على فرد أقل منه مرتبة. وبسبب من هذا، فتراتبية العلاقات في مجتمعاتنا لا تقوم على التكامل، بل على التناقض، فأنت لن تنجح في ظل نجاح الآخر، وأنت لن ترتفع إلا فوق رقبة أخرى، في الوقت الذي تقبل فيه أن تحني رقبتك طواعية لآخر. الانشطار الانفعالي، إذن، تقليد عربي أصيل، يذهب بعيدا في عمق العقلية العربية. تقول الدكتورة هناء المطلق، أثناء دراستها الشخصية الخليجية، في كتابها “الغائب”: “الولد في العائلات التقليدية يعرف أنه إذا تكلم فعلى الإناث ومن هم أصغر منه من الذكور أن يصمتوا، وأن تقدم له الطاعة والتصديق، والاهتمام الشديد لكلامه، بغض النظر عن فحوى ذلك الكلام”، وكأننا أمام نسق من القمع، يقابله نسق من الخضوع، يتم التأصيل لهما، على مستوى الأسرة والمجتمع، ففي داخل الأسرة مثلا، يتم تعليم الفتاة كيف تكون حكيمة، مع أخيها، وليست هذه الحكمة إلا الاستسلام له، وتلبية أوامره، وهي طواعية تتحول إلى حكيمة مع زوجها، وحتى مع أولادها الذكور. ولعل كل واحد منا سمع في مرحلة من حياته، أمه أو أباه يشيران إليه ملقنيه إكسير الحكمة: “من خاف سلم”، ولن يكون بدعا من القول أن نقول: إن هذه الحكمة هي الحكمة الوحيدة التي بقيت للعرب من تراث الأجداد، والتي يمارسها العربي على كل المستويات. والسؤال الذي يفرض نفسه، وسط حمى المظاهرات، وضجيج الديموقراطيات ودعاوى الحريات، كيف يراد للمجتمعات العربية أن تحقق الديموقراطية، وهي تمارس الدكتاتورية والاستبداد على كل المستويات، وأصغرها؟ ومتى ترتقي الديموقراطية العربية لمستوى أرقى من الضجيج والصراخ؟ أو بصيغة أكثر وجعا: متى يكتمل الإنسان العربي؟ |
*الوطن عدد 31/12/2006