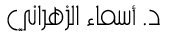تساءلت في المرة السابقة عن زعم امتلاك الحقيقة، وعن موقع هذا الزعم في الصراع التاريخي بين الدين والإرث الثقافي للمجتمع، وهما قضيتان حاضرتان بقوة في كثير من أزمات واقعنا، فجزء مما يجره زعم امتلاك الحقيقة إلغاء الآخر أو عدم الاعتراف به, وهذا ما دفع أحد الخطباء في مسجد جمعة أن يخصص موضوع خطبته في التنبيه على غالبية المصلين وهم من جنسيات عربية مختلطة، ليقول في ربط غير موضوعي بين قصة هداية الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو لقومه، كونه كان سفيرا إليهم في نقل الدين الصحيح , وبين حال المقيمين في بلادنا وضرورة إفادتهم من مكوثهم في بلادنا (غير كسب الرزق) من خلال ممارسة شبيهة لما قام به الطفيل. حيث قال بجزم قاطع إنهم (أي المصلين المقيمين) لم ولن يجدوا العلم النقي إلا في هذه البلاد، متناسيا قصدا أو سهوا مدرسة علماء الحديث في الهند وما قدمه ويقدمه الأزهر ودمشق والقيروان.
يمثل موقف هذا الخطيب تناقضا كبيرا يظهر في الخلل الذي شوه الحقيقة التاريخية ومسخها في ذهنه، وهو تشويه لا يقوم على مجرد فهم ساذج منقوص للتاريخ، بل ينبني على موقف من الحقيقة ، قد يمثل منظومة فكرية مأزومة في إدراكها للحقيقة، وهي منظومة أفرزت الكثير من الأزمات الكبرى في تاريخنا المعاصر، لعل على رأسها العنف الفكري والجسدي والنفسي الذي نمارسه في تعاملاتنا، والذي أفرز ظواهر العنف التي أحدها ما تمارسه فئة من الشباب المغرر، حين تزهق أرواح الآمنين باسم الدين والخلافات حول قضاياه.
ويحيل موقف هذا الخطيب على تناقض كبير بين موقف الدين الذي يتحدث باسمه من العنصرية والعصبية، وموقفه المتعالي على الأخوة المقيمين. وهو موقف لا يخلو من دلالته أيضا، فلا يخفى على أحد ذلك الربط بين المكانة الدينية والمصداقية وبين عناصر معينة في المجتمع، على أساس إقليمي عرقي، ربطا يذكرنا بظاهرة التفاوت العرقي والتفاضل على أساس النسب، وهي ظاهرة تسربت من العرف الاجتماعي للدين، وتم الخلط بينهما بشكل عجيب، بحيث أضحت هذه القاعدة الاجتماعية التي نزل الوحي برفضها وإنكارها، معيارا يتم تحكيمه في التقييم الديني للأفراد والجماعات.
في القصة السابقة دلالة تاريخية ذكرتني بسلسلة مقالات للكاتبة سهام القحطاني حول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، في تحليل ملفت للدعوة وجوهرها الحضاري التجديدي، فما يحيل عليه موقف الخطيب في القصة السابقة هو الاستقلال الذي منحته الدعوة الوهابية لتاريخ هذه البلاد ودورها الديني الكبير في التاريخ المعاصر، وهو استقلال يبدو أنه هو الذي أمد الرجل بموقع فوقي، تحدث منه للآخر الذي يمثله الأخوة المقيمون. وموقف هذه البلاد وتاريخها الديني المعاصر حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، لكنها تسببت في كثير من الأذهان المرتبكة بهذا الخلط بين الفعل والفاعل. وعلى العكس مما تمثله هذه الدعوة من إحياء وتجديد لمباديء الدين الحنيف، التي من أهمها رفض العصبية العرقية، وتحكيم العقل والمنطق والحوار البناء مع الآخر، نجدها انتهت لدى بعض ممثليها إلى تناقض كبير مع ذاتها، تمثل في هذه النظرة الفوقية للآخر، والتحاكم في الدين والفقه الديني على أساس عرقي.
تثير هذه القضية سؤالا تاريخيا مشكلا، إذ كيف نجحت الدعوة الوهابية نجاحا منقطع النظير في إلغاء البدع وتنقية الدين من الخرافات والجهل العقدي , بينما فشلت في إلغاء العنصريات والعصبية القبلية؟ وهل كان هذا ناتجا عن عدم التفاتها لهذا العنصر؟ أم أن ما حدث هو تشويه لهذه الدعوة وفق سلوك اجتماعي معين خاضع لظروف المجتمع وتحولاته الثقافية؟ في العلاقة الشائكة بين الدين والموروث الاجتماعي لمجتمع ما، قد يقف العقل الجمعي موقفا مختلفا من الدين، ويلتف حوله بدلا من مواجهته، وهذا هو ما يحدث حين يتم تطعيم غير محدود بين الدين وهذا الموروث، بحيث يتماهى هذا بذاك، ويصبحان في موقع واحد، ومع مرور الوقت يصبح هذا المجتمع ممثلا للدين وناطقا عنه، في تماه مطلق بينهما بحيث يحل أحدهما محل الآخر، من دون تمييز. هذا ما يمكن استنتاجه من القصة السابقة، التي يمكن تنزيلها على كثير من ظواهر المجتمع الإشكالية فيما يتعلق بالحقيقة الدينية والأزمات الناتجة عن الاختلاف حولها. وهذا ما يمكن أن يفسر مآل الدعوة السلفية الوهابية في علاقتها ببعض موروثات مجتمعنا، ومنها تسرب معايير الفكر العشائري، إلى منظومة الفكر الديني، الذي يريد بعض المنتسبين إليه تضييقه على مقاس مجتمع واحد، بدلا من انطلاقه للعالم واستيعابه للبشرية كافة، وهو الدين الذي ارتضاه الله للإنسان على علمه باختلاف أجناسه وألوانه وظروف حياته.