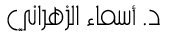يقول رسول الهدى – صلى الله عليه وسلم – : “من قال: هلك الناس، فهو أهلكهم”، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرتني هذه الحكمة النبوية، وأنا أتأمل ظاهرة تعتري حياتنا الاجتماعية، تهز استقرارها، وتحول دون تقدمها ونمائها. تلك هي ظاهرة التصنيف، التي هي بدون مراء من أهم معوقات الحوار، والتواصل الاجتماعي البناء. وتحديدا أعني تصنيف هوية الإنسان، ومحاكمته، وإقصاءه، وفقا لذلك التصنيف، بحيث لا ينظر في خطابه الفردي، بل يحسب على فئة معينة، يحاكم على خلفيتها، فتلغى شخصيته، وعقليته، لحساب المجموع. ناهيك عن أن يكون التصنيف غير محايد، بمعنى أن ينحاز لسلوك التنابز بالألقاب، الذي صار حمى تعتري صحفنا ومنتدياتنا الثقافية، فما إن يتصدى متحدث لقضية من القضايا حتى يتم تصنيفه، فهو محكوم بأن ينتمي لأحد الفرقاء، أو أن يلتزم الصمت، ضنا على طاقته الفكرية مما يتلقاها من الهدر. وكم من الهدر الفكري نمارس يوميا، غير عابئين بما نهدره من حساباتنا الحضارية، ضمن ما نهدره من طاقاتنا المالية والبشرية على أرصفة الشوارع، أو في وجوه الرصاص الطائش الثائر.
في زمن النبوة، وقبل انقطاع الوحي، ظهرت فئة المنافقين، وتكاثر عددهم، حتى شكلوا فئة لها حضورها في المدينة النبوية، ونزل فيهم القرآن الكريم، بآيات متفرقات، وسورة كاملة. وأوضح القرآن الكريم علامات النفاق، وسيماء المنافقين، تحذيرا للمجتمع المسلم من فتنتهم، لكن اللافت للنظر أنه لم يحدد أسماءهم، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بالاسم. ويقال إنه ائتمن أحد صحابته على تلك الأسماء، فما الحكمة من ذلك التكتم على أسماء المنافقين، طالما أن أذاهم وكيدهم للإسلام والمسلمين، يضرب بقوة، في صلب الدعوة المحمدية، والدولة المسلمة الناشئة؟ ألم يكن ذلك وعيا منه صلى الله عليه وسلم بخطورة التصنيف، وسلبياته في المجتمع المسلم؟ ألم يكن ذلك ترسيخا لخلق حضاري رفيع، ظاهره حفظ وحدة المجتمع، وباطنه حفظ الطاقات الفكرية من هدر التصنيف؟
لسنا بصدد مناقشة النظرية الاجتماعية وقسيمتها الفردية، كما هي في قاموس علم الاجتماع، لكن أهم ما اتفقت عليه الأفهام، أن المجتمع البشري، تتميز بنية المجموع فيه، ونسيجها، عن باقي المجتمعات، بارتفاع القيمة الفردية لأعضائها. وقد ناقش القرآن الكريم هذه الميزة البشرية، في قوله تعالى:”وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا”، فبقدر ما يكون الفرد في المجتمعات الحيوانية نسخة تلخص خصائص المجموع ؛ يكون المجموع في المجتمع البشري عبارة عن بنية منفتحة، تظل تكتسب صفاتها من تنوع أفرادها، وتحركهم في سلم الحضارة صعودا ونزولا. ومثل أي بنية، لا يساوي المجتمع البشري مجموع أفراده، بل هو تمثيل للعلاقات القائمة بينهم. وعلاقة التكامل هي التي تطبع بنية المجتمعات في حال تقدمها وازدهارها الحضاري، مثلما تحكم علاقات التفكك والتنافر والعشوائية بنية المجتمعات المتخلفة. فكيف تكون علاقة التكامل، والتنوع الحميد، في ظل ثقافة التصنيف، والتنميط للكائن البشري المتفرد؟
يفترض أن يمتلك كل منا خطابه الخاص، الذي يكونه عبر تفاعله مع مختلف أفراد مجتمعه، وأحداثه. وكذلك الكاتب، الذي مهما صنف نفسه، يظل مطالبا بأن يراجع ذاته، وينقح خطابه، عبر الحوار المستمر مع ذاته، ومع غيره. والمرونة والتطور والمراجعة المستمرة للذات، هو ما يفترض بنا أن نمارسه عبر الكتابة، وهذا ما يعطي للحوار والمثاقفة / بمعنى التهذيب، معناهما وفعلهما الحضاريين. وفق ذلك، يفترض أن يكون كل نص جديد، بمثابة أفق جديد، يتم مراجعة الخطابات السابقة عليه في ضوئه، سواء خطاب الكاتب، أو حتى الخطابات المختلفة التي تتجاذب الحوار. وقديما قيل: إن الرجال يُعرفون بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال، لكن ما يحدث في ثقافتنا عبر سلوك التصنيف، هو قراءة النص في ضوء تفسير/تصنيف مسبق، وتنزيله على قالب جاهز، بحيث يتم إلغاء كل ما لا يتطابق مع هذا القالب، أو حشره فيه، على سبيل التأويل.
ليبرالي، أصولي، متطرف، مفرط، جامي، سروري، علماني … إلخ، وتصنيفات أصبحت تحتاج لقاموس لكثرتها. ومن الطريف أن يتم تصنيفك لفئة لم تكن تعرف بوجودها. ويأتي ضرر التصنيف، من عدة جهات، أولاها:إلغاء فرادة العقل، وخسارة ما يمكن أن تعطيه وتنتجه هذه الفرادة، عبر الاختلاف المثمر. وثانيها:ترسيخ مبدأ الصوت الواحد، الذي تتبعه سياسة الإقصاء للرأي الآخر. وثالثها وأخطرها: قتل مبدأ الحوار، الذي بواسطته يفترض أن يتكامل أفراد المجتمع، ويتبادلوا الأخذ والعطاء، في شؤون حياتهم ومصالح مجتمعهم .
*الوطن 10/11/2006