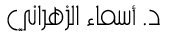مقالا تلو مقال، ظللنا نشير بأصابعنا لمواطن الجراح، وننادي، والحمد لله، يمكننا أن نفخر اليوم بما أنجزناه على صعيد حقوق الطفل، السعودية العظمى2019
عكاظ 2007
تعقيبا على مقالي السابق حول يوم الطفل العالمي، وجدت رسالة في بريدي من أحد القراء، تقول بأن الطفل في مجتمعنا ينال أكبر قدر من العناية، ولست أدري بأي معيار قاس القاريء الكريم هذه العناية، إلا إن قصد معيار الترف المادي الذي نغرق أطفالنا به، ويمثل وسيلة التخاطب الوحيدة التي نستعملها مع أطفالنا. ولعله اعتمد في ثقته المفرطة وحسن ظنه على التوثيق الإعلامي المشوش، وهو إعلام لا يزال يجهل وظائفه الحقيقية، أو هو غير قادر على الوفاء بها في معظم الأحيان، فمن كان يجرؤ على الكتابة عن مقتل طفلة على يد والدها قبل سنوات قليلة من الآن؟ لقد كانت مثل هذه الأمور التي تخدش الصورة اليوتوبية لمجتمعنا المنزه عن الخطأ محذورة إعلاميا، ولم يكن ذلك توجها ناتئا عن المجتمع، فمن طبيعة المجتمعات العربية التي تحفل كثيرا بالسمعة والصيت حتى ولو كانا فارغين، التستر على عوراتها، والتقليل من حجم أي مشكلة تخدش جمال صورتها، وفي الواقع، كان هذا الدور فضلا عن التجميل المبالغ فيه، هو الوظيفة الوحيدة التي كان يمارسها الإعلام العربي، ولا زال يمارسها فطريا ودون وعي في أحيان كثيرة، وهذا ما يجعلنا لا نعتمد كليا على الإعلام في تحديد مشاكل الطفولة وأزماتها في مجتمعاتنا.
سجلاتنا في أرشيف الطفولة، كان سؤالا ينتظر إجابة حادة، تنغرس في الضمير كشوكة مسمومة، فمن لم يقض ليال متخمة بالخوف والتفجع بعد أن تابع مقتل الطفلة أريج، التي لفظت روحها بعد معاناة التعذيب والتشويه البدني والنفسي الذي تعرضت له على يد والدها وزوجته الثانية؟ ولم تكن أريج الوحيدة، فالمطلعون في مستشفيات ومراكز شرطة بمدن المملكة يعرفون أن عددا من الحالات المماثلة سبق تسجيلها ، وإن لم تنته جميعها بالموت، لكن هذه الحالات مهما كانت ندرتها تبقى مؤشرا بالغ الخطورة على أن مجتمعنا بحاجة ماسة إلى مراجعة حساباته فيما يخص الطفولة المهمشة بأكثر من شكل. لقد هالني ما قرأته من تفاصيل حول تلك الجريمة البشعة، وإن يكن تناولها جاء بشكل موجز وخجول في صحفنا، كما جاء مثلا في تقرير الأستاذ سعيد العدواني في جريدة المدينة، في السادس من شوال.
وقد ناقش الكاتب عبدالله أبو السمح هذه القضية، ونبه على خلفيتها التشريعية التي تتعلق بحضانة الطفلة، والتساهل في شأنها من قبل الجهات المسؤولة، وكانت أسرة والدتها قد لجأت إلى القضاء بشأن حضانة الطفلة وعدم أهلية والدها لها، وتجاهل القضاء ظروف القضية واعتمد حرفية النص الشرعي كما يحدث غالبا في قضايا الحضانة. ومن يضطر للجوء للمحاكم في دعوى طلاق وحضانة، سيلاحظ بوضوح كيف يتم الفصل بين عملية الطلاق وحق الحضانة ووضع الأطفال، مع أن القضيتين مرتبطتان بشدة، ولا ينبغي فصلهما، بل ينبغي ألا يتم البت في الطلاق قبل الاطمئنان على وضع الأطفال، وضمان حقهم في المحضن الكريم المناسب. وهكذا تم البت في طلاق والدي أريج، من دون الالتفات لوضع الطفلة في تلك السن الحرجة، ومن ثم استغرقت قضية الحضانة سنوات طفولتها التي انتهت بجريمة بشعة. وفي العالم المتحضر يحظى الطفل بحق حماية حتى من والديه في حال إساءة معاملته، ويحظى برقابة ومتابعة يتحمل مسؤوليتها المجتمع، مدرسته وجيرانه مثلا، فمن الطريف أن تتابع المدرسة في بريطانيا وأستراليا مثلا أوضاع الطفل في البيت، مع والديه وأسرته، بينما يتم إهمال متابعة وضع الطفل لدينا في أحرج حالاته، في حال انفصال الوالدين، واضطراب ظرف معيشته الأساسية واستقراره.
اقترح الأستاذ أبو السمح رفع سن الحضانة لتفادي مثل هذه الحالات، وهو اقتراح عملي، لكنه يحتاج لمراجعة شرعية من قبل المختصين، كما أنني قرأت للأستاذ مصطفى عزب مقالا تحدث فيه عن خط ساخن للتبليغ عن مشاكل الأطفال، وهو اقتراح عملي آخر، وما هذه الأصوات هنا وهناك إلا جزء من مراجعة ضرورية نحتاج لمواصلتها حثيثا في سجلاتنا مع الطفولة، ولا ننتظر حوادث بشعة كمقتل أريج لتوقظنا من سباتنا، وندردش قليلا حولها ثم ننسى. الموت المادي والمعنوي، سلب حق الحياة الكريمة الصحيحة، هو أحد أهم التعديات الممارسة على الطفل، والتي ينبغي مناقشتها بالأرقام والإحصائيات، والوقوف عليها بجدية وتجرد تام.
كلنا يعلم النسب المرتفعة للطلاق في مجتمعنا، لكن معظمنا يتغافل عن الحقيقة المفجعة التي تتمثل في معاناة الأطفال جراء هذه النسب. فتعرض الطفل للتمزق النفسي نتيجة انعدام الوعي التربوي لدى الأبوين المنفصلين أو أحدهما ينتج عنه شخصية مضطربة، غير قادرة على النمو السليم والتوافق الناجح مع البيئة والمجتمع والذات، وهذا ما يبشر بأسر مضطربة يؤسسها هؤلاء الأطفال مستقبلا، فكيف هو تصورنا لما ستحتضنه تلك الأسر من ضحايا مفترضين من الأطفال الذين يشكلون أكثر من نصف مجتمعنا؟ إن المعاناة التي يتعرض لها الطفل هي مقصدنا بالدرجة الأولى، فمن يحفظ حقوق هذا الطفل المهضومة في الحياة الكريمة؟ هل سنترك هذه الحقوق للصدف التي توفر للطفل أحد الأقارب المهتمين، أو حظا جيدا بمعدل ذكاء يساعده في مواجهة ظروفه؟ لا يتوفر مثل هذا الحظ لجميع الأطفال، وهذا ما ينتج حوادث الجنوح المتكاثرة هذه الأيام، لذلك نحتاج لتدعيم عامل الرقابة المجتمعية بهذا الشأن وتوفير منافذ قانونية لتفعيل تلك الرقابة.
لقد حظي التاريخ العربي بنصيب الأسد في الصورة الشائهة للتعامل مع الطفولة، حين كانت شريعة الوأد تحكم أجزاء كثيرة من بلاد العرب، وقد خلد القرآن هذه الوصمة في تاريخ البشرية بالسؤال الخالد: “وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت”، فمتى سنمضي جديا في محو هذا التراث بكل ظلاله وانعكاساته من سجلاتنا مع الطفولة المؤودة؟