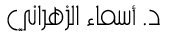2007
في ورقتي هذه كنت أنوي تناول رواية القاصة : نورة الغامدي ، لكن الحصول على هذه الرواية لم يتيسر لي في الوقت المناسب ، برغم حرص المسؤولين في النادي الأدبي بالباحة على تيسير حصولي عليها بإرسال نسخة ، ابتلعتها دهاليز البريد الأعشى . وهذا بحد ذاته جزء من مشاكل تلقي العمل الإبداعي في بلادنا ، صعوبات النشر المحلي ومشاكل التوزيع ، ومن ثم صعوبة التواصل بين المبدع والقاريء ، ومن ثم القطيعة التي تؤدي إلى زهد كل من الطرفين في الآخر ، وبالتالي جهله .
منذ سنواتي الدراسية الجامعية وأنا أسمع عن قصص الكاتبة ، قرأت بعضا منها في الصحف , وكنا نسمع عن إصداراتها ، ولا نعرف كيف نحصل عليها . مع روايتها كان الأمر أصعب ، ظللت أشاهد حضورها المتقطع في الوسط الإعلامي ، عروض للرواية هنا وهناك ، وظلت الصعوبة في الحصول على العمل مانعا دون قراءته رغم حرصي . ولما تفضل النادي الأدبي بدعوتي للمشاركة في هذا الملتقى ، كانت هذه الرواية أول ما خطر بذهني ، استأنفت محاولاتي للحصول على الرواية ، وأثناء ذلك عثرت على مجموعتيها القصصية ، التي رأيت أن قراءتها ضرورية لاستيعاب جو الرواية ، بما أنها امتداد لتجربة سردية انطلقت من القصص القصيرة .
وحين اطلعت على المجموعتين القصصية للكاتبة ، وجدتها جديرة بقراءة مستقلة ، فعكفت على قراءتها ، ولم أستطع الخروج من جوها . وبين أيديكم هذه المحاولة المختزلة ، للتسلل إلى العوالم السردية التي بنتها المبدعة “نورة الغامدي” ، عبر مجموعتين قصصيتين مميزتين ، الأولى بعنوان : “عفوا لا زلت أحلم ” ، والثانية بعنوان : “تهواء” . انقلب الأمر إذن ، وصارت الرواية رافدا لقراءةٍ محورها القصة القصيرة لدى نورة الغامدي ، أتمنى أن أواصل مشاهدة جريانه في متسع من الوقت ، خارج إطار هذه المناسبة المحدود زمنا .
رحلة البحث عن الكنز :
كان أول ما لفتني في نصوص الكاتبة نورة الغامدي القصصية ، اتكاؤها كثيرا على الموروث ، وإذا ما نظرنا للموروث على أنه نص مكتمل ، فسنجد أن الكاتبة حريصة على أن تنشيء نصوصها بالاشتباك مع هذا النص ، لغته ، رموزه ، مرجعيته الفكرية ، بحيث تكاد نصوصها تكون امتدادا لهذا النص ، حنينا إليه ، واستدراكا عليه . وتبدو الحكاية ، هي البنية التي اختارتها الكاتبة ، من بين البنى التي يتقلب في مفاصلها الموروث بوصفه نصا . الحكاية/ اللغة ، والحكاية/ الثقافة ، بما تحمله من روح ذلك الزمن ، غير المنبتة عن جذورها في طينة الفكر الأسطوري .
في قصة “من كم جدي” ، في مجموعتها “تهواء” ، تصوّر الساردة _ وهي حفيدة من أحفاد الجد سعيد _ جدها في ثياب أبطال الحكايات . الجد الذي يسافر إلى حاضرة مكة ، بحثا عن الكنز / أو ذاته ، فتفشل رحلته ، ويعود للقرية يائسا ، حيث يبتكر حيلة يحقق من خلالها ثروة طائلة ، ليجد الكنز ، في المكان الذي تجاهله ، في ذاته وهي تتنفس هواء القرية . في حيلة الجد ، يتم تكثيف العلاقة بين الريف والمدينة ، وزمن كل منهما ، بطريقة سردية غاية في الطرافة ، فالجد يفشل في التعايش مع المدينة بروح ابن الريف ، تلك الروح التي تدفعه لمساعدة أحد الحجاج كبار السن ، فيعبر له الحاج عن امتنانه ، بإهدائه أداة تكنولوجية أحضرها من بلاده ، منظار يختزن عددا من الصور ، تمثّل رحلة الحج ومناسكها كاملة . وحين يعود للقرية ، يقنع الشاب أبناء قريته بالحج عبر منظاره ، الذي يخبئه في كمه ، ويساعدهم على اختصار رحلة الحج المضنية لدقائق ، مقابل مبلغ من المال .
وعقلية الريفي البسيط في هذه القصة ، لم تكن ساذجة بقدر ما كانت تعيش زمن الحكايات ، زمن توحد الإنسان بالمكان ، والكائنات حوله . بتلك العقلية صدّق أبناء القرية وجودهم وسط حاضرة مكة ، يؤدون شعائر الحج ، ويعودون ولما يتحركوا من أماكنهم . يدعم هذا الجو الحكائي ، مكان الحدث ، وهو وادي مهجور مسكون بالجن ، فيه تكتمل أسطرة الحدث ، حيث يستدير الزمن ، وتختفي الفواصل الزمكانية بين الكائنات . هكذا يستدير الزمن تماما ، ويعود رمز الفشل ، المنظار ، الذي كان نشازا في حقيبة الجد ، ليتحول أداة للنجاح ، حين يتم دمجه في منظومة المجتمع الريفي ، ووضعه في موضعه من عقلية الريفي البسيط . وقريبا من هذه الحيلة للجد سعيد ، كانت حيلة بائع المسابح ، في قصة “”روح برقان تعيد ترتيب القرية” ، الذي حل كثيرا من مشاكل القرية ، ومنها مشكلته الخاصة ، باستغلال الفكر المشحون بالحكايات وعجائبيتها .
في القصة ذاتها ، أبناء الجد سعيد هم امتداد لوالدهم ، تعرض الساردة عبرهم ، معاناة ابن الريف ، المقدر له الترحال كأبطال الحكايات ، باحثا عن ذاته . وفي نهايات تلك الرحلات ، ينجح البطل أحيانا ، في تذويب الفاصل الحاد بين زمن الريف وزمن المدينة ، ويفشل في ذلك أحيانا ، فيواجه فشله بابتكار زمن غير واقعي يهرب في دهاليزه . شخصيات القصص تبدو كما لو كانت هاربة من صفحات الحكايات ، أبطال نمطيون وأفعال نمطية ، عقدة وحيلة ، وأحيانا أمراء ، كما في قصة “الطاقية” مثلا ، لكن الكنز الذي يبحث عنه كل هؤلاء الأبطال ، هو الذات المتأرجحة حد التمزق ، بين زمنين .
تمثل الحكائية في قصص الكاتبة مظهرا من مظاهر حضور الأسطورة ، بزمنها ومنطقها العجائبي ، أو بلا منطقها ولا زمنها على الأحرى . يردّنا هذا الحضور الأسطوري إلى منطقة اللاوعي الجمعي ، فاهتمام الكاتبة بالعلاقات الأسرية لا يمكن تجاهل دلالته . وإذا ما ربطناه بالمرجعية العامة لنصوصها القصصية ، الطابع الاجتماعي المشتبك بالحكائي ، فخطابها –إذن- هو خطاب أمومي ، فهي كأم تنتهج مراقبة الأسرة ، عبر مشاكل كل عضو فيها ، وتحاول دمجهم في أسرة منسجمة ، تتجاوز تناقضات موقعها الممزق ، بين زمن الريف وزمن المدينة . هذه هي وظيفة أبطال قصصها غالبا ، فهم أعضاء في أسرة ، وأدوات لتوازن الأسرة الافتراضية الكبيرة . الأسرة التي تتخذ فيها الكاتبة موقع أم ، تحتضن جيل بكامله ، وتروي عليه حكايات ، تصنع بها ذاكرة يتكيء عليها فهمه لواقعه وتوازنه معه . ولن يكون طارئا حضور هذه الأم الساردة وحكاياتها ، ممثلة في بطلات قصتها : “الأمهات الثلاث” ، وهن ثلاث شخصيات حميمة ، الأم وجارتين لها ، يحكين للساردة البطلة حكايات خرافية ، ليهيئن لها خبرات تتكيء عليها في صنع مستقبلها الزوجي المقبلة عليه .
اللغة ، مفتاح الكنز :
تبعا للجو الحكائي المشحونة به قصص المجموعتين ، موضوع هذه القراءة ؛ تأتي تقنية الرمز ، بكثافة وعمق ، لتكون أبرز تقنيات السرد ، وأكثرها ثقلا . ويتصل الترميز فيها بالموروث الاجتماعي-الذي عددناه من قبل نصا معقدا- ، في كل مستوياته ، مما يعني أن على القارئ أن يستحث طاقة ذهنية ضخمة ، ليندمج في حركة الرمز ، الذي يطال علاقته بالماضي ، وموقعه في الحاضر والمستقبل ، وكل خبراته الاجتماعية ، في شكل شبكة مركبة ، يصعب تحديد أطرافها . يعيدنا ذلك إلى مصطلح من مصطلحات المنهج النفساني ، تم استخدامه في نظريات القراءة . أعني به مصطلح الجشتالت ، الذي وظفه الناقد الألماني (وولفغانغ آيزر) في دراسته لفعل القراءة . وهو مصطلح يحيل إلى عملية ذهنية معقدة ، تحكم إدراك القاريء للنص المقروء ، تتسم بالعلاقات التي يكتشفها القاريء ، أو يعيد تركيبها بين ما هو داخل النص ، وما هو خارجه . وعبر فعل القراءة ، يعيد القاريء بناء موقعه في زمنه ، وإدراك أبعاد وجوده ، حيث يدرك القاريء النص من خلال السياق ، ويعيد إدراك السياق من خلال النص .
هذا التوظيف الرمزي للموروث ، يضطر القاريء للحركة بين منظومتين ثقافيتين مختلفتين ، فالقصص تعالج الراهن ، بلغة تمتاح مرجعيتها من التراث . وذلك أحد وسائل المعالجة السردية ، للمشكلة / الإطار للقصص ، وهي تمزق الأبطال بين قيم الماضي والحاضر . واضطرار القاريء للحركة المركبة التي تجبره على تأمل موقعه من الزمنين ، وحركته بينهما، يسهم في إعادة التوازن لاضطراب الإنسان الذي عانى تلك التجربة ، . وتأتي اللغة هنا – من منظور نفساني- معادلا موضوعيا لذلك الإنسان ، حيث استطاعت اللغة ، أن تدمج الزمنين في كينونتها ، وحضورها في القصص ، فهي لغة تتم عبر بنيتها الرمزية ، ممارسة الحاضر بروح الماضي .
والمنهج النفساني في قراءة العمل الأدبي – وإن لم يعن هذا بالضرورة وعي الكاتب بأدق تفاصيل كتابته- كان قد شكّل موجة ، تأثر بها الكتاب كما النقاد ، ولا زالت مصطلحاته ترفد علوم الإنسان ، بما تتوصل إليه من تأويلات هذا الكيان الغامض . وهكذا سنجده حاضرا في أشكال مختلفة ، في عدد من المظاهر ، تتجمع في نقطة اختيار الكاتبة لشخصيات مضطربة نفسيا وعقليا وعاطفيا ، محاور لقصصها ، و رواة لها. وانطلاقا من هذه النقطة ، تبني الكاتبة علاقات قصصها وحبكاتها ، وفق منظورات المنهج النفسي ، وتفسيره للإنسان .
الكتابة من موقع :
يمكن تناول القصص من جهة ثانية ، فيما يتعلق بالسرد ، وأعني بالسرد : الموقع الذي تتخذه الكاتبة زاوية نظر ، تعالج من خلالها القصة ، وتبني الحبكة . والشخصيات الساردة في قصص الكاتبة نورة الغامدي ، هي شخصيات إما نجحت في تحقيق التوازن ، أو تعيش مرحلة عنق الزجاجة من تجربتها ، وتترك للقاريء مهمة الخروج منها . ومتابعة لما سبق ، ومن خلال اختيار نمط الشخصيات المضطربة نفسيا للسرد ، يتم توظيف نمط وعي هذه الشخصيات في تحقيق مواقع للسرد ، تخدم الخطاب الذي تحمله القصص .
في قصص نورة الغامدي ، نحن أمام تجربة جيل يعيش صعوبات الانتقال بين زمنين متناقضين ، تقدم الكاتبة هذه التجربة عبر زوايا نظر متنوعة ، بقدر تنوع الرواة ، وبقدر تنوع الشخصيات المحورية في قصصها ، سواء كانت ساردة أو محورا للقصة ، استطاعت الكاتبة اختيار الموقع المناسب ، لالتقاط تفاصيل الشخصية ، وهي تنشيء علاقاتها ، وتبني بذلك جسم السرد ، ومراقبتها بالدقة الكافية لصنع مشهد كلي مقنع للقاريء . واختيار الكاتبة لمواقع الساردين في قصصها هو جزء من لعبة المواقع ، فالسارد غالبا هو شخص يعالج قضية من موقع متعال ، حتى مع كونه بطلا للقصة كما في غالب القصص ، نجده يروي من موقع محايد ، كما سيأتي .
في مجموعتيها، تحاول الكاتبة معالجة قضية تمزق الإنسان ، بين قيم الماضي والحاضر ، من خلال أصوات من الجهتين . الساردة لقصة الجد سعيد – مثلا- هي حفيدته ، وهي تنظر للماضي من حافة المستقبل ، من منظور جدها . وفي القصة نفسها ، يتم توظيف صوت الجد بالتبادل ، حيث الجد سعيد ينظر من حافة الماضي إلى الحاضر والمستقبل ، في أبنائه ، وأحفاده . وعبر الصوتين تحاول موازنة موقف الإنسان من تناقضاته الحادة ، في موقعه المهتز بين زمنين متناقضين .
وإذن ، فاختيار الشخصيات المضطربة لموقع السارد هو جزء من لعبة المواقع، فهي شخصيات مضطربة نفسيا ، منفصلة عن الواقع ، تحاول الكاتبة من خلالها ، رؤية المجتمع في الماضي والحاضر ، من مسافة بعيدة كفاية ، للإحاطة بتفاصيله والحكم عليه . وهي بسبب اضطرابها تعيش حالة من التنقل غير المنتظم عبر الزمن ، فتقترب من الراهن المحكي ، وتبتعد عنه بالعودة للماضي ، أو القفز للمستقبل ، في حالة اهتزاز الوعي بالزمن والواقع معا . وبذلك التنقل عبر الزمن ، هي تتخذ مواقعها من المحكي ، بشكل يمنحها زوايا نظر أوسع ، مثلما يتعامل الرسام مع لوحة ، يقترب منها ليشاهد الجزئيات ، ويبتعد عنها ، لتتسع زاوية النظر ، ومن ثم يجيد رسم التفاصيل والعلاقات الكلية . ويبدو أن الكاتبة من خلال اختيار أصوات قصصها ، المنفصلة عن زمنها ، تحاول صنع توازن من نوع ما ، بين الماضي والحاضر المتناقضين ، من خلال تقديم كل من الزمنين بأصوات منفصلة عن زمنها ، في منظورات تلتقط المختلف ، وتترك للقاريء صنع الائتلاف .
نذكر على سبيل المثال شخصية الابن ، أمام تسلط والده ، في قصة “الدم” ، إذ يعيد الابن بناء موقفه من والده ، عبر حلم ، يقتل فيه الوالد ، ويتقمص شخصيته ، في محاولة للنظر من منظور الوالد ، وبمعايير القيم التي يعتنقها ، ويظل الابن في تأرجح مفتوح النهاية ، بين موقعه وموقع والده . لا يبعد عن ذلك ذهول الابن أمام سلطة الأم في قصة “السر” ، وعجزه عن اتخاذ موقع محدد من وجوده ، واهتزاز تصوّره لنفسه بحيث يفقد هويته ، ويسمى باسم أمه : “علي ولد موسيّه” . وكذلك بطلة قصة الطاقية ، حين تسكن قصة اخترعتها في طفولتها ، هروبا من زمن آخر ، لم تستطع التكيف معه .
هذا التحكم بزوايا السرد ، ناتج من وجهة نظري ، لأن الكاتبة تــكتب من موقع فعلي قوي ، متكئة على تجربة قوية ، هي هنا تجربة الاغتراب عن الذات ، بسبب تحولات المجتمع ، السريعة والمربكة من مجتمع القبيلة ، إلى مجتمع المدينة . وهي تجربة جيل ، بل أجيال لا زالت تعاني خللا شديدا ، واهتزازا في موضوع الخصوصية ، في زمن العولمة المفروضة من منطق العصر الراهن . يمكن استنتاج عمق التجربة التي تتكيء عليها الكاتبة ، من خلال إعادة بناء أفق ، تلتقي فيه قصصها ، لنجدها تشير إلى موقع الكاتبة ، ضمن تجربة واحدة ، تتخذ صياغات مختلفة ، وزوايا نظر متعددة ، لقضية تم إشباعها بشكل ملفت .
الفضاء النصي :
هل يبدو من المنطقي ، في قصص نورة الغامدي ، تحليل الفضاء الزمكاني بين الحكاية (في صورتها الأولية) ، والقصة (الحكاية بعد إعادة بناء حبكتها)، بمنطق يفصل بينهما ، بحيث يتم تمييز التحولات التي تطرأ على سببية القصة وزمنيتها ، وعلاقاتها الداخلية ، أثناء تحولها لخطاب بواسطة السرد ؟ الجواب من وجهة نظري ، أن ذلك لن يكون منطقيا ومجديا في قصص نورة الغامدي ، فالفضاء في الحكاية الخام ، لدى نورة هو فضاء نمطي ، لا يتميز بالكم بل بالكيف ، هو كما وصفناه ، فضاء واقع بين فضاءين متناقضين ، جغرافيا وزمنيا ، زمن المجتمع الريفي ، تحت سيادة المؤسسة المجتمعية ، وزمن العصر الحديث ، زمن الفرد المطلق ، الذي لا يمكن تحديد جغرافيته لشدة تنوعها ، وحدّته. هذا هو فضاء القصة لدى نورة ، الفضاء الذي تتراجع أمام سلطته – كإطار عام للقصص – استقلالية االفضاء الواقعي في كل قصة على حدة . أما فضاء السرد لدى نورة ، فهو فضاء أسطوري مطلق ، وهو شكل آخر لفضاء نمطي ، يمكن وصفه بالكيف لا بالكم ، وبهذا يغدو التمييز بين الفضاءين بلا جدوى في قراءتنا المقترحة لقصص نورة الغامدي .
والفضاء الأسطوري زمنا ومكانا ، هو المناسب لاسترجاع التوازن لروح إنسان الريف ببساطته وتوحده مع الطبيعة ، في عصر لا يعترف سوى بالواقعية الصلبة ، ومنطق المادة وسطوة التقنية وغياب القيم . وهو فضاء ، الزمن فيه مطلق ، تذوب فيه الفواصل بين اللحظات الزمنية التي تؤلف الزمن المنطقي ، بلحظاته الثلاث ، الماضي والحاضر والمستقبل . ذلك الزمن الأسطوري المطلق ، هو الزمن الذي تعيش فيه شخصيات القصص ، التي يغلب عليها الاضطراب العقلي أو النفسي ، زمن الحلم ، أو زمن الوهم الذي يصنعه الهذيان والتهيؤات . وهو زمن لا يتحقق إلا في مكان يستوعب قوانينه . وهكذا كان المكان في قصص نورة الغامدي ، فالمكان في قصة مثل قصة السقف ، هو غرفة أسطورية ، تتحدث جدرانها ، هكذا يحكي لنا بطل القصة وساردها ، أو هكذا يصنع بمخيلته فضاءه الخاص . وفي قصة الرسام ، المكان هو بيت زوجية وهمي ، تعيش فيه وتتحرك زوجة وهمية . وهكذا تبدو الشخصيات المضطربة ، كما لو جاءت لتلائم الفضاء الأسطوري للقصة ، الذي سبق أن خلقته ، في حركة دائرية مفتوحة الطرفين ، يتميز بها الفضاء الأسطوري ؛ فهي شخصيات مضطربة غالبا لدرجة الجنون المطلق ، أو الذهول الحالم في أفضل الأحوال .
الهوية والسرد :
“الهوية السردية” ، مصطلح ضخم ، يمثل فلسفة متكاملة للوجود من خلال فعل السرد ، لدى الفيلسوف والمفكر الرنسي “بول ريكور” ، مصطلح يشف عن مفهوم مترام ، على تخوم عوالم الفلسفة ، والنقد ، والتاريخ ، والتأويل . ولست بصدد التعمق في توظيف هذا المفهوم المتشعب للهوية السردية ، لكني أحببت أن أستل ناحية بسيطة تتعلق بالجانب النقدي منه ، إنما هي برغم بساطتها ، جذرية في جانبيها الاثنين : الهوية ، والسرد . وبحسب هذه الجزئية ، يرجع ريكور ، جانبا كبيرا من السرد ، لوظيفة وجودية ، ليس بمعنى التوظيف الاجتماعي الساذج ، وإنما بإقامة تواز بين فعلي : الوجود والسرد ، ففعل السرد هو فعل وجودي ، يتم عبره تحقيق الذات ، وتشكيل الهوية ، وممارسة الوجود بكل تجلياته ، الواقعية البسيطة ، وخلفياتها الفلسفية . وفي المقابل ، الحياة بوصفها فعل وجود ، تتضمن الكثير من آليات الفعل السردي ، تقاطعاتها ، مفاجآتها ، بنية الزمن فيها . الحياة كما يصفها ريكور هي حبكات متكاملة ، غنية بكل أسرار الفعل السردي ، وليس هذا فقط ، بل إننا نستخدم السرد بمعناه الخام ، فكثيرا ما نحل أزماتنا ، ونتفاعل معها بسرد القصص ، نحن نسرد القصص لأطفالنا لكي يناموا ، ونسرد القصص في جلسات الأصدقاء ، وننفس عن عقدنا الخفية بالأحلام ، وهي مستوى آخر من السرد . السرد إذن ، كما الحياة ، داء ودواء ، فكما هما يمثلان وجها لمعاناة الوجود ، يمثلان في الوقت نفسه حلول للتعايش مع هذه المعاناة ، التي هي أول المعاني وآخرها .
من هذا الجانب ، وهو رغم بساطته ، جذري في السرد المحلي ، والعربي بصفة عامة ، رأيت أن أقرأ قصص المبدعة “نورة الغامدي” ، التي تكشفت فيها نواح جميلة وقوية للهوية السردية ، كما رأينا . وهي جزء من دراسة أعمل عليها ، لنماذج من الأعمال المحلية ، فبمعنى ما : تكاد تكون الأعمال العربية جميعها ، تنفيسا عن أزمات تهدد الهوية ، أو تركت فيها آثارها بالفعل . وقد شكلت أعمال الكاتبة جزءا من الدراسة ، على أنه جزء لم يزل في طور البناء والإضافة ، إلا أني أحببت المشاركة به في هذا الملتقى الكريم .
يمكن الجزم بأن مواضيع القاصة نورة الغامدي يدور أغلبها في حقل الأسرة ،
ضمن مجتمع القبيلة . شخصياتها غالبا ذات موقع في أسرة ، لنقل إنها تحضر بوصفها عضوا في مؤسسة ، فالأسرة في المجتمع القبلي ، هي مؤسسة ضمن مجتمع قائم على نمط اجتماعي ، الفرد فيه هو تمثيل للمؤسسة وقوانينها . هكذا كان الرسام في مواجهة طقوس مؤسسة الصداقة ، والجد في قصة “من كم جدي” ، الأب والإبن في قصة “الدم” ، الأم في قصة “السر” ، الزوجتان وطقوس ليلة العيد ، في قصة “الليلة” . والأمثلة تتعدد بعدد القصص في المجموعتين ، لكننا نحتار بشأن رضى السارد في كل قصة ، عن هذا الطابع المؤسساتي للحياة ، فهناك تأرجح واضح بين رفضه لذوبان الفرد حد الاضطهاد ، وبين اشتياقه لقيم الأسرة وروابط القبيلة ، وإن كان يفوح من لغته غالبا نوع من الانتماء لهذه الأجواء ،ففي قصة “الليلة” ، مع أن بطلتها أم فارس ، تعترض على ظلم الزوجة الأولى ، واستغلالها لموقعها في الأسرة ، تظل الساردة تصف بزهو طقوس العيد في القرية . ويكاد الاعتراض على هذا المجتمع المؤسساتي ، لا يأتي فقط إلا حين يسيء الأفراد استخدام هذه السلطة ، كما الأب المتسلط في قصة “الدم” .
يبدو أن الكاتبة تحاول أن تحيي منظومة قيم اجتماعية مفقودة ، قيم المجتمع الريفي ، الحب والسخونة العاطفية سلبا وإيجابا ، نقرأ نورة الغامدي حتى في هواجيسها “زاويتها في الثقافية”، تهجس بأراوح الأسلاف وقيمهم . هكذا نجد أبطال القصص ، شخصيات حالمة ، تهرب من تناقضاتها ، وتعيش زمنا افتراضيا ، انتقائيا ، يتم بناؤه على خلفية المجتمع الريفي وقيمه . مثلما يتبدى لنا بطلا قصتي “الدم” ، و”العنود” : شخصيتان حالمتان ، أحدهما فنان مرهف ، والآخر فلاح بسيط ، مع اختلاف ردود الفعل على جفاف الواقع ، حيث اختار أحدهما التسامي على الواقع ، واختار الآخر مواجهته الصدامية بفعل القتل . ويبقى موقف السارد ضبابيا ، والقيم شديدة التأرجح والمأساوية : أيهما الأقوى ؟ الهروب في صورة تسامي ، أو الهروب في صورة مواجهة عنيفة ؟
تعرض الكاتبة نمطا من الشخصيات ، هو نمط الإنسان الذي يعيش الزمن المتحول ، المنطقة الزمنية الضبابية ، التي تربط زمنين متناقضين . زمن المؤسسة ، وزمن الفرد ، زمن القبيلة والأسرة الممتدة وقيم المجتمع القبلي ، وزمن المدن الشاسعة التي تختفي فيها الألقاب ، ولا يعود الواحد فيها يساوي أكثر من نفسه . إنسان هذا الزمن الضبابي ، يعاني صراعا في منطقة القيم الإنسانية النبيلة ، وموقعها بين طرفي المعادلة الاجتماعية : المؤسسة والفرد . صراعا بين ذاته التي لا زال يراها في اندماجها داخل منظومة المؤسسة المجتمعية (القبيلة ، الأسرة ) ، وتوحدها مع طقوسها ، وبين ذات أخرى لا يمكن أن تتحقق في حضور الأولى ، ذات الفرد المتضخمة المستقلة . ما ينتج عن ذلك هو ذات ثالثة تمثل التقاء افتراضيا بين الذاتين ، هي ذات مغتربة ، وهائمة في اللامكان واللازمان . تنجح القاصة في التقاط العديد والمتنوع من صور هذا النمط الإنساني ، في حالات واقعية وشديدة الاحتمال .
في ذلك الفضاء الواقع بين فضاءين متناقضين ، في منطقة ضغط شديد يدمر كل ما يعبره ، يصبح الصراع الذي يعيشه إنسان ذلك الزمن محتدا ، لدرجة انعدام التمييز ، فيهرب البطل لعالم خيالي حالم ، أو هذياني مشوش ، ليخلق حالة من التوازن النفسي الوهمي . عالم يقبل بحالة الحياد التي يرفضها منطق الواقع العملي ، ففي الواقع العملي ، الإنسان مطالب بفعل ، والفعل مستحيل التحديد في زمن ضبابي المنطق ، ولهذا فمن المناسب أن تتشكل الشخصيات ، وتتحول تحت سطوة تناقضات الواقع ، بشكل يسمح لها بالتكيف مع فضاء اللامنطق ، الذي يخلقه ذلك الواقع . فضاء يتشكل بأفعال الشخصيات اللاواعية : الحلم والهذيان والذهول ، والتي تشترك جميعا في لغة تقوم على الترميز . تلك الشخصيات تخلق فضاءاتها الأسطورية ، التي تنفصل فيها عن واقعها ، كونها ممزقة بين موقعين متناقضين ، لا يمكنها التنصل من أي منهما للاندماج كليا في الآخر ، ولا يمكنها من ثم اتخاذ مواقع محددة ، تمنحها صيغ حضور مقنعة في زمنها الراهن .