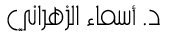مكة
السبت 10 ذو القعدة 1435 – 06 سبتمبر 2014
على مشارف عام دراسي جديد، نتطلع كل عام للتقدم خطوات، يستحقها تعليمنا، بما تقدمه الدولة من ميزانيات ضخمة، توازي ميزانيات دول في الجوار.
ونلمس هذا التقدم في مجالات عديدة، لكن ما أود الوقوف عنده هو قياس مخرجات التعليم العالي.
وما يلاحظ بهذا الخصوص أن المعايير انقلبت، فكاد التعليم العالي يستغني عن تطوير المهارات البحثية، وهي محط الاختلاف بينه وبين التعليم العام، وصار تضييق المراجع العلمية لأقصى حد هو المتبع غالبا، لتناسب التقويم بواسطة الاختبارات، بما لا يدع للتقويم العملي مجالا سوى مجال هش لا يوظفه سوى قلة من الأكاديميين لأسباب أخلاقية.
ولا أظن أن هناك خلافا بشأن الفارق الكبير الملموس بين مخرجات التعليم العالي سابقا ومخرجاته اليوم، فعلى الرغم من تسهيل أدوات البحث العلمي، يلحظ المهتمون عدم إقبال الطﻻب على استثمارها.
وعلى الرغم من التوسع في إقامة المؤتمرات العلمية الطﻻبية، يلمس من يتابع شح المشاركات، وتدني مستواها العلمي.
وهذا ما يؤكد أهمية الالتفات للتقويم العملي، المعتمد على المشاريع والأبحاث، فلا يكفي أن تقام المؤتمرات العلمية، ما لم يوجد طالب التعليم العالي، الذي أُعِدّ ليكون باحثا لا حافظا، ولا أعني بالباحث أن يعمل أكاديميا فحسب، لكنه في كل مجال يعمل فيه، سيعمل بعقل الباحث المتعمق، المطلع على الجديد في تخصصه ومجال عمله، ما يجعله كادر عمل منتجا، ﻻ عنصرا في بطالة مقنعة.
منذ عقود تسعى الدولة لتطوير المناهج، وتنفق بسخاء في هذا السبيل، وفي سبيل التخلص من التعليم المبني على التلقي السلبي.
ومن وجهة نظري يتعثر هذا المشروع وتظل المناهج في حيرة من أمرها ما دام تطوير وسائل التقويم مهملا، إذ كيف يقاس تعليم حديث بوسائل قديمة؟! وكيف نتخلص من التلقين ما دمنا نرسخ في ذهن الطالب أنه يدرس ليختبر في نهاية الفصل؟! وماذا يثبت اﻻختبار الموضوعي على أية حال؟ إن نجاح أي مشروع يعتمد على وضع معايير دقيقة وسليمة لقياس مخرجاته، وفيما يتعلق بالتعليم العام قبل العالي، ينبغي أن نضع في الحسبان أننا إذ نربي الطالب الباحث المتسائل، نبني مواطنا محصنا ضد الغواية واﻻختطاف الفكري، ونبني وطنا يتنفس النهضة، والنماء.