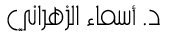الوطن 17/9/2006

تحدثت في المرة السابقة عن خطر التصنيف، وعواقبه الوخيمة على الحراك الاجتماعي السليم، من قتل للحوار، إلى وأد للأصالة. وأوردنا كيف ينبني على التصنيف السلبي، إقصاء فئات بكاملها عن المشاركة في الرأي العام، في الوقت الذي أثر في ديننا أن: الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وهذا يقودنا إلى تلمس نوع من الهدر الفكري، يتم فيه قتل الحوار، الذي يقوم على احترام الأطراف المتحاورة بعضها لبعض، لا على التنابز بالألقاب، والتصنيف الجائر. ومن جهة أخرى، يحدث الهدر الفكري حين يتم وأد الأصالة الفكرية للأفراد، لحساب الجماعة التي ينتمون إليها، وتتحدث باسمهم.
وللتصنيف آليات وحيل، لا يعجز عن تطويرها المتفننون في سياسة الهدر الفكري. ولعل التأويل هو أهم آليات التصنيف، وأنجعها، فإذا تم تصنيفك مبدئيا لفئة بعينها، فسوف يتم تأويل كل ما تقوله لخدمة هذا التصنيف، وترسيخه. وعلى مدى التاريخ الإسلامي كان التأويل وسيلة لفتح المعنى، كتب ابن قتيبة كتابه “تأويل مختلف الحديث”، ليفتح للمعاني طرقا تلتقي فيها النصوص الصحيحة الإسناد، المتعارضة المعنى، فهو تأويل للمصالحة إذن، للتأليف لا للإقصاء. وحتى تأويلية المعتزلة في الأسماء والصفات، كانت ـ برغم مخالفتها لنهج أهل السنة ـ ترمي إلى المصالحة والتأليف بين النص والعقل، عبر فتح المعنى. أما في ثقافتنا اليوم، فقد استخدم التأويل وسيلة لمحاصرة المعنى، تتم عبره مصادرة النص، لصالح الإقصاء، الذي هو هدف القراءة المتحيزة الضيقة. ما أود الوصول إليه، هو أن هذه الفوضى التأويلية التي تعم ساحتنا الثقافية والاجتماعية، والتي تم استخدام التأويل فيها كسلاح لغلق المعنى لا لفتحه، كسلاح للتصنيف والإقصاء، ليس لها أي مسوغ منهجي، ولا شرعي، لا من قديم ولا من حديث.
القراءة المجتزأة، هي ثاني آليات التصنيف، حيث يتم اقتطاع جزء من النص، جملة واحدة أحيانا، ويتم تركيبها وسط قالب مصنف جاهز، لإثبات انتماء الكاتب لهذا القالب. وهو أمر تلافاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين جاءه من يشكو رجلا فقأ عينه، فتمهل في الحكم، حتى يرى الخصم الذي جاءه مفقوء العينين، وهذه ليست قصة طريفة فحسب، بل هو سلوك يعلمنا مغبة النظرة المجزوءة، وضيق زاوية النظر.
في كتابه “القارئ والحكاية”، تناول الناقد الإيطالي، أمبرتو إيكو، عملية القراءة، في طابعها التأويلي، مفترضا أن أي نص هو نص مفتوح المعاني بتعدد القراءات، وأورد مثالا على أطروحته قصة، مفادها أن وزيرا لإحدى الدول، تم اختطافه من قبل جهة إرهابية، وسمح له بإرسال رسالة إلى دولته، فحرص على أن يدس في الرسالة شيئا من الإشارات تفيد في إنقاذه، وإنقاذ موقف دولته. وبالفعل، اختلف مفسرو الرسالة، وكل منهم قدم براهينه وحججه على معقولية معناه، والنص حمال أوجه كما قيل في التراث الإسلامي.. ولست أذكر على وجه التحديد ماذا حدث للوزير المسكين، لكن ما يهمني من القصة، وهو أهم ما توقف عنده إيكو في ذلك الكتاب، هو أن معنى النص ليس ملكا خالصا للقارئ، بل هو محكوم بإشارات النص أولا وأخيرا، مما يثبت وجود القراءة الخاطئة، أو التأويل الخاطئ، وهذا التأويل الخاطئ، هو الذي لا يجد له أي سند من النص، بل الذي تتعارض معه إشارات النص وعلاماته اللغوية، وهذه القراءة الخاطئة، لا يمكن التعرف على خطئها إلا تحت نور الضمير الحي، والضمير الحي يختفي صوته كثيرا وسط الجدل والمراء الدائر حول التفاصيل قبل الكليات. لكننا إن أردنا الإنصاف فسنعرف كيف نكشف عن وجه القراءة الخاطئة، عبر قراءة محايدة متوخية الإنصاف والعدالة.
أما أغرب آليات التصنيف، وأطرفها، فهي أن تصنف نوافذ الإعلام، وفي بلد تحكمه عقيدة واحدة، ودستور واحد. والغرابة في ذلك أن الوسيلة الإعلامية أول شروطها الحياد، فهي مجرد قناة للمعلومة والرأي. ولذلك تتنافس وسائل الإعلام في مقدار الحياد والشفافية في قنواتها، ثم ينبني على تصنيف الوسيلة الإعلامية، شيء أغرب وأكثر إجحافا، ألا وهو تصنيف الكاتب للجهة التي يكتب فيها، ورغم علمي بما يحدث من تصنيف للصحف وفقما يغلب على اهتمامات كتابها، إلا أني أعتقد أن هذا أمر يعود للكتاب أنفسهم، وانحيازهم لتكتلات كتابية معينة، هنا وهناك، وليس لكون الصحيفة أو القناة الإعلامية، تمنع كاتبا أيا كان من أن يتخذ من مساحاتها منبرا للكلام.
تناولنا خطورة التصنيف، وآلياته، بقي أن نعرف من هم ضحايا التصنيف؟ الضحية الأولى هي الكاتب المحايد، الذي بدلا من أن يكون ثقة لكل الفرق، وصديقا لها، يكون عدو الجميع، وفق قانون بوش الشهير: من ليس معي فهو ضدي، وهو في حياده لا يمكن أن ينحاز دائما لصالح فئة، فلكل فئة أخطاؤها وحسناتها، حاشا فئة القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة، ثم ما اتفقت عليه الأفهام السليمة والأعراف الزكية، فهي فئة الكاتب المحايد، الذي لا يسلم عقله لمن يستعمله نيابة عنه.
الضحية الثانية، القارئ العامي، الذي يزداد غربة عن الواقع، تحت ضغط خطاب التكتلات والإقصاء، حيث يتم ردعه عن التفكير، وحبسه في زاوية نظر واحدة، وهو الذي تعلم أن يبرئ ذمته في رقبة المفتي. وهو يطبق هذا السلوك في كل شؤون حياته، فهناك دائما من يفكر بالنيابة عنه، وكأنه مفرغ من آلة التفكير خاصته، العقل الذي خلق الله لكل منا واحدا، يحاسب ويجازى عليه، “كل امرئ بما كسب رهين”.
أما الضحية الكبرى فهو المجتمع، الرأي العام، والحوار الوطني الصحي، فكل رأي حر ومستقل، ستتم مصادرته بتصنيفه، وتفريغه من سياقه الخاص، وتذويبه في سياقات أخرى غريبة عنه، يفقد معها أصالته، وجدواه. ولا يبقى لدينا إلا تكرار المكرر، وشرح المشروح، وقوالب جامدة، لا تقبل أي جديد، ولا يقبل أصحابها استبدالها بدوائر الخطاب المفتوحة، بدلا من الجدل البيزنطي الفارغ.