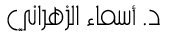حين نتحدث عن العنوان في نص أدبي نكون نتحدث عن هويته، اسمه في بطاقة التعريف، لكن العنوان في الرواية السعودية يتعدى وظيفة التعريف بالنص المكتوب إلى التعريف بالذات الفاعلة للكتابة، بل إنه يغدو معادلا لهوية تلك الذات وممثلا لحضورها وكيفيات هذا الحضور. والهوية في الرواية السعودية بدأت منذ عقد من الزمن تتخذ موقعا متوترا ضمن مكونات المشهد الإبداعي، ففي بيئة منطوية على ذاتها وتعيش عقدة الخوف من كل شيء خارج تلك الذات، كان صعبا للغاية أن ينفتح الإبداع على صيغ وجود تخالف ولو بقدر يسير هين مكونات تلك البيئة وأطرها الكثيرة جدا على الحصر. هذا هو الواقع الذي وجد الروائي فيه نفسه وهو يحاول بعث الحياة في نماذج الشخصيات التي بدأت تتململ في قمقمها لتخرج للوجود.
بعض تلك النماذج جزء من واقعنا عاش مخبئا في الظل، فحاول أن يخرج للنور، وبعضها نشأ بفعل التغير الاجتماعي الذي عاشته البلاد في العقود الماضية، من دون أن يجد فرصة للحضور والتعبير عن ولادته ونضجه بيننا. نماذج كثيرة أخذت تتطلع للخروج والمشي في الهواء الطلق بحرية، لكنها لم تجد مكانا لممارسة هذا الحق البشري سوى بين دفتي رواية، على صفحات ورقية، في فضاء يتخذ من الخيال جواز مرور لولوج الفضاء الاجتماعي الواقعي. إنها صورة مبتسرة للفعل الوجودي المرتبك، الذي لا زال يعاني آثار الخوف والقمع، بحيث يتخذ دائما قناعا يختفي وراءه، لكن هذا القناع يغدو أيضا وسيلة أخرى للفعل الوجودي ، بتوظيفه كعلامة على الهوية المستلبة، حين يمارس الروائي خلق شخصياته خلف اسم مستعار، لأسباب لم تعد تجد لها مكانا في الجو المنفتح الذي تتنفسه الرواية السعودية اليوم، على أقل تقدير بقدرتها على توظيف النشر في الخارج. التخفي، والضيق بالتخفي والثورة عليه باستغلاله وسيلة للظهور بطريقة تجنب صاحبها الخطر، وسائل متعددة تمارسها الذوات في مرحلة الهروب المحموم من عنق الزجاجة، تلك هي المرحلة التي تعيشها الرواية السعودية اليوم، فإما أن تخرج من الزجاجة للفضاء الرحب، أو تختنق في مكانها، أو لعلها تختنق لتبعث من جديد في صورة أكثر نضجا وعافية من كل آثار الخوف والارتباك.
الهوية إذن صيغة وجود مهددة، يتم الدفاع عنها بآليات سردية، من أبرزها توظيف العناوين وأسماء المؤلفين كعلامات فارقة للنصوص، وحين نضيف لمصطلح العلامة مفردة (فارقة) فإننا نتقصد هذه الإضافة لإخراج العلامة من حيزها العلمي (في الفكر البنيوي) الذي اشتغلت فيه ضمن بنية لغوية منغلقة على ذاتها، إلى فضاء العالم الخارجي حيث تتحول إلى مكون دلالي يكتسب وظيفته من التعالق مع ما هو خارج اللغة، حيث يتم تعريف العلامة اللغوية بحسب تعريف قدماء منظري البنيوية بما تسلبه منها العلامات الأخرى ضمن النظام المغلق للغة، لتكون كل علامة قالبا منجزا يستعمل ولا يعمل، بينما يمكن تعريفها في جانبها الدلالي بما تضيفه هي للغة من فعل حيوي مستمر.
يتم توظيف أجزاء مهمة من فضاء النص، بدءا من العنوان، وليس انتهاء بأسماء الشخصيات والأماكن، لخدمة حضور الهوية (في مواجهة الخطر الذي تتعرض له بوصفها ممارسة وجودية، أمام تسلط جهة أخرى كالمجتمع وموروثاته مثلا ). ومن مظاهر هذا الحضور توظيف الاسم المستعار للمؤلف، لأغراض تتجاوز فعل التخفي والهرب من المواجهة. والاسم المستعار للمؤلف يكاد يكون حرفة سعودية بامتياز ، وإن سبقنا إليها آخرون فلأسباب مختلفة ، ف”زينب” لهيكل ، لم تكن تحمل أسبابا أيديولوجية لاختفاء صاحبها وراء اسم مستعار ، بل كان الاسم المستعار وسيلة لمواجهة ردود الفعل المتوقعة على تجربة جديدة كل الجدة ، تجربة رائدة ، يخشى صاحبها عدم تقبل الجمهور لها ، بينما الاسم المستعار لدينا يرجع لخلفيات أيديولوجية ، أبعد ما يكون عن الفن ، فخلف الأسماء المستعارة يكمن الخوف من مواجهة المجتمع لا بوصفه جمهورا فنيا ، المجتمع بتقاليده وتكوينه الأيديولوجي الصارخ ، الذي يمارس بمختلف الطرق وعلى كل المستويات رفض الآخر ، وموقف الجمود والشك والريبة تجاه الآخر المختلف . الاسم المستعار يظل في النهاية نوعا من علامات غياب الهوية وكبتها ، في مقابل هوية مهيمنة ، من خلال حضوره كعلامة قوية تتربع على الغلاف ، الذي يحتل موقع الوجه وبطاقة التعريف في فضاء النص الروائي ..
الأسماء المستعارة لها وظائف أخرى ، فهي تقوم بدور العلامة على أشياء عديدة ، رسالة الرواية مثلا ، ومعظم الروايات التي تحمل أسماء مستعارة لمؤلفيها تحمل رسالة أيديولوجية ، مثل اسم مؤلفة الرواية في رواية “الآخرون” ودلالته على المذهب الشيعي من خلال اختيار لقب عائلة الحرز المعروف في الوسط الشيعي . وكذلك “القران المقدس” لمؤلفته طيف الحلاج ، وهو اسم يحيل على الحلاج ، رمز التمرد على المجتمع ، والخروج على الثوابت . ولن أبالغ في تفسير اسم المؤلفة : هاجر مكي في : “غير وغير” .. ومؤلف رواية “الأوبة”.
و في الروايات السعودية هناك بالمقابل نوع من الولع باستعمال الأسماء كعلامات فارقة داخل النصوص، أحمد الدويحي ، مثلا ، في المكتوب مرة أخرى يسمي مهنة “الكنس” ، علامة على فعل السرد ورمز له ، ويظل يحددها ويزيد من تحديدها مع كل شخصية تضاف إلى قائمة الكناسين في الرواية ، بل انه يحولها الى ما يشبه الحرفة المقننة التي لها شيوخها ومحترفيها وأصولها وتأصيلاتها ، فهناك شيخ الكناسين وحفيدته وكناسون موزعون في أنحاء العالم ينتمون إلى كيان معروف محدد ، له قوانينه ، وله أهدافه ربما ، والمعلوم من أهدافه بحسب الرواية ، هو كنس الشوارع والمدن وحياة الناس من خلال فعل السرد ، بحثا عن المعنى ، وما هو المعنى سوى الهوية ، التي يظل الكناس الرئيسي / سارد النص يشكلها طول زمن الرواية من خلال فعل السرد الذي يشكل موضوع الرواية ، فالقصة في المكتوب مرة أخرى تدور حول بطل يحاول كتابة حياته والتعرف إلى ذاته وتحديد معالمها من خلال كتابة رواية ، واختيار شخصيات روايته ، تلك الشخصيات التي تمثل كل شخصية منها رمزا وعلامة على شيء مستقل، (شخصية بلقيس مثلا). ولا ننسى أن اختيار السارد البطل وهو يمارس الكتابة بطلات للنص وليس أبطالا ، هو نوع من الانحياز لقضية
أقلية من نوع آخر ، ليست أقلية في العدد ، ولكن في الوجود ، والحضور ، هي الأقلية الأنثوية والحضور الأنثوي مقابل الذكوري ، فبلقيس مثلا هي صورة لاستحضار مجد الحضور الأنثوي من خلال بلقيس الحقيقية ملكة “سبأ”.
كذلك كانت أسماء أصحاب الحصون التي يتنقل بينها البطل ، كل اسم له دلالته الخاصة ومعناه المتعلق بهوية صاحبه، ورغم أن بعضها يمتنع على التفسير الدلالي ، كـ”أم الورد” مثلا ، إلا انه يفصح عن رمزيته بتعمد بنية الاختلاف فيه ، فأم الورد مثلا هو اسم لرجل وليس لأنثى ، وهذا وحده يثير الأسئلة ، ويضع علامات الاستفهام حول هوية أم الورد . ولا تختلف أسماء الشخصيات في نماذج أخرى من سرود الكاتب الدويحي، فلا تخفى دلالاتها داخل الروايات من خلال أفعالها ووظائفها السردية. هكذا كان “صابر” بطل مدن الدخان وكذلك “سامح ، وفوزية وبسمة” ، كلها أسماء تشف عن دلالات معينة لا يمكن تجاهلها ، لا سيما صابر ، الذي عاش مكابدة الحياة وقضاها معاناة انتهت في مستشفى الشميسي .
وتظهر قضية شفافية الأسماء الدلالية أيضا لدى روائيين آخرين عديدين، منهم الروائيين أمل الفاران وعبد الحفيظ الشمري ، لكنها أوضح ما تكون لدى أمل الفاران في (روحها الموشومة به) ، فتوظيف الاسم هو محور مهم في تقنيات السرد في هذه الرواية ، التي تعلن عن وجودها من خلال فعل الوشم (العلامة) ، وهو نوع من التسمية الصارخة من خلال أقوى طرق تثبيت الاسم / الوشم .. وبطلة أمل الفاران جزء من وجودها يكمن في اسمها ، وسمية ، وتظل بطلة النص تفسر وجودها الواقعي من خلال حركة الأسماء / الرموز في الحلم ، وهي رموز تحضر من خلال الأسماء كعلامات على نوع معين من الحضور .
في فيضة الرعد لعبد الحفيظ الشمري، سندلف الى فعل التسمية من العنوان ، فيضة الرعد ، فهي منطقة كثيرا ما تتجاوب فيها الرعود كدلالة على حركة إيهام تشارك فيها الطبيعة ، فرعود فيضة الرعد لا تأتي دائما بالخير ، بل تتفاوت بين كونها أصوات وضجيج خالي من المضمون ، أو أن تكون نذيرة سيول مدمرة فتاكة، دلالة على التطرف المناخي ، الذي قد يكون على علاقة بالتطرف في ذهنية المجتمع ومخياله ، قد يكون لفيضة الرعد اسم آخر ، له علاقة مثلا بحياة بطلتها غزالة ، وهو اسم البطلة الذي يأتي بدوره رمزا للجمال الأنثوي الصارخ ، لكن اختيار اسم فيضة الرعد يمثل علامة على دلالة طريفة للعمل ، وهو سلوك التطرف الذي يسري من الطبيعة إلى الواقع الاجتماعي ، فبين الغنى والفقر ، يعيش مجتمع فيضة الرعد في تمزق صارخ بين بيئتين متفاوتتين تفاوتا صارخا ، في ظروف المعيشة وتقاليد الحياة اليومية شديدة الرغد في مقابل شديدة الشظف .. كما يعيشون تحت رحمة سلوك الطبيعة المتطرف تارة للجفاف والقحل ، وتارة للفيضانات المدمرة .