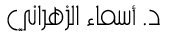أصابتني صدمة ، نوع من الصدمة المعرفية أو العاطفية ، مثل انفلاق البحر تحت أقدام موسى عن يابسة ، لا أدري ما الذي حدث بالفعل ، إنه نوع من السفر في المجهول ، في مجاهل الذات ، وأي شيء أكثر غموضا من داخلك؟ ، وقررت ساعتها أن أكتب ، لم أفكر ماذا أكتب ، ولو فكرت فلن أجد ، فلي فلسفة في الكتابة ، هي أشبه شيء باللا فلسفة ، أن الكتابة هي حدث ، وهي توجد في الزمن الحاضر فقط ، لا يمكن القبض عليها في الزمن الماضي ، وإن تكن مفتوحة على المستقبل ، وهكذا كنت أترك كل قصائدي تكتبني ، وكنت أرفض خربشة أي ورقة أكتبها بدعوى التصويب ، فلا أخطاء في الكتابة ، إنما أحداث ، يجب أن تمضي في سبيلها ، وتترك أثرها للعين التي ستنشيء منها أحداثا أكثر وأكثر ، في مسلسل من الخلق لا ينتهي .
القراءة أيضا ليست إلا تنويعا على الكتابة ، هي كتابة بشكل ما ، تكتب العين أكثر مما تكتب اليد بكثير ، فمهما حاولت الآن أن أقيد ما حدث ، فلن أستطيع حتى الاقتراب من بعض ما سطرته عيوني في تلك الليلة ، في المسافة بين دفتي دفتر أزرق مكتنز ، لم أكن أفكر في الاقتراب منه قبل أن يسقط من الرف وينفتح على الأرض ، عن تلك الصورة الباهتة ، لوجه أجفلتني تقاطيعه حد الذهول . تلك الصورة اللعينة ، لم تفعل بي أقل مما أستحق على تطفلي الأحمق على حجرته ، كانت صورة لوجه مليء بآثار الجدري ، مغروسة فيه عينان ، تضيق إحداهما بشكل يدعو للنفور ، ذلك الوجه المجدور ، انتبه لرؤيته مرة واحدة ، عدد من أطراف عصبية ، تشكل مع ملايين غيرها ، في تجويف جمجمتي ، ما يسمى بالذاكرة . لم أكن أعرف أن له هذه المهارة في الرسم ، فما أراه ، وأصر على رؤيته كصورة ، لم يكن إلا رسما ، أتقنته أصابع لم تتعود إتقان أي شيء ، سوى العبث بأزرار الهاتف ، في نهارات قائظة ، لا تحتملها طويلا حتى الأصباغ البباهظة الثمن التي تختبيء خلفها وجوه الجميلات التائهات على سكك البحث عن ذات لم تجد فرصة لأن توجد أصلا .
…. أخذ يبكي كطفل حين أيقظته أمي لصلاة الجمعة ، وبدلا من أن يصرخ كعادته ، عند أي خلاف ، ويترك المنزل هائجا ، انطوى في سريره في استكانة لا تليق به ، والتف بصمت لم ينته قط . لم يكن قبل ذلك اليوم يعرف الصمت إلا مجازا ، كان طول وقته يتكلم ، بلسانه وعينيه ، وحتى بقصات شعره وألوان ملابسه المبتكرة في كل مرة . أخذت حالته منذ ذلك اليوم في تدهور سريع ، لم يستطع الأطباء تفسيره بأكثر من تفسير نفسي غامض . رفض الخروج من غرفته مطلقا ، قبل أن يصبح عاجزا عن الوقوف متوازنا . كان يوقظنا كل ليلة تقريبا على صراخه بكلمات مبهمة ، واستغاثات مطلسمة ، عجزنا عن تفكيكها في سبيل حكايتها لمفسر الأحلام الشهير ، لعلنا نعثر على الدواء في إحدى تلك المنامات ، التي تؤمن أمي بأن لها معنى ما .
حين رن جرس الهاتف ، لم يكن رنينه مختلفا عنه في كل مرة ، لكن كل ما في المنزل هب فزعا ، حتى نبتات الظل المتراصة بمحاذاة السلم الدائري ، الذي يتوسط المنزل ، حتى هي خلتها لوت أعناقها باتجاه الهاتف . “وجدناه ملقى على قارعة الطريق في مكان يبعد عن المدينة أربع ساعات ، على جثته آثار عراك وخنق” ، وجدوا في معدته (بعد التشريح) كمية من الحبوب المخدرة كافية للوفاة ، بحيث تبدو آثار الخنق بلا معنى . كان قد خرج مع صديق له ، في لحظة تحسن مفاجئة ، وطلب من صديقه أن ينتظره ليدخل أحد الأسواق ، ولم يخرج بعدها .
” سامحيني يا أمي ، بعض الغياب ، هو الطريقة الأفضل للحضور
أحمد “
كان الدفتر الأزرق ، كالبحر يموج بأسرار مبهمة ، عجزت عن تفسيرها ذلك النهار المشؤوم، كانت طريقته في تسجيل مذكراته تعتمد على الرمز والتشكيل ، كأنما كان يستعد لعين غريبة تتطفل عليها ، حتى انفلق في تلك اللحظة ، عن الحقيقة الصلدة ، ولم يكن هناك من أثر لأي رسول ، يمكن لحفنة منه أن تغير شيئا مما جرى . صور الوجوه الشائهة ، تنتشر كالجدري على الأوراق البيضاء ، وبالحبر الأسود الفاجع ، رأيت الحكاية بدون رتوش ، تختبيء خلف طية لركن ورقة من أوراق الدفتر . بالرسم والتاريخ نقش أحمد صورة لما جرى في ليلة سماها بليلة إعدامه . لم يكن لأحمد صديق أقرب من نفسه ، وهذا ما يفسر هذا العدد من دفاتر المذكرات الثخينة ، التي تملأ رفوف مكتبته ، لكنهم كانوا أصدقاءه على أية حال … كانوا أصدقاءه ………. .
أسماء الزهراني