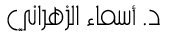تعد آليات الذهنية النقدية العصب المشترك في كل وجوه النشاط البشري، لا سيما النشاط الفكري. إذ تنبني سيرورة المجتمعات البشرية على آليات المراجعة والغربلة المستمرة للمنجز في أفق التوقع. النقد في عموم الاصطلاح يشمل هذه الآليات، وهو لا يستثني منها حتى نفسه.
نحن هنا إذن أمام منطقتين مستقلتين نظريا، منطقة النقد في تعامله المباشر مع الظواهر، ومنطقة نقد النقد. في المنطقة الأولى لدينا آليات نسبية تتكيف بحسب الظاهرة التي تناقشها. في المنطقة الثانية نحن أمام آليات فكرية عامة ليس بمعنى التبسيط، وإنما في بعدها الفلسفي الذي يجعل منها أدوات لتحليل الفاعلية النقدية المتعالية في تجردها عن تطبيقاتها. الأولى منطقة العلم والثانية منطقة الفلسفة. . العلم من حيث هو ابتكار القواعد والقوانين وانتهاجها، والفلسفة من حيث هي وضع القوانين محل تساؤل. وإلى هذا التساؤل يرجع الارتباط الأزلي بين الفلسفة والنقد، حيث كل نظرية نقدية لها أساسها الفلسفي، وكل فلسفة يقع في مركزها النقد.
وفيما يلي أحاول مقاربة المشهد النقدي المحلي من خلال مناقشة آليات تحركه، والبحث فيها عن ملامح الذهنية النقدية التي قلنا إنها مرتكز كل نشاط بشري إيجابي. ومصطلح (مشهد) هنا لم يأت اعتباطا، ذلك لأنني سأستعير بعد قليل مفهوم المنظور السردي في هذه المقاربة. والمنظور الذي هو اختصار لزاوية النظر هو مصطلح استعمل في نظريات القراءة، لدى الناقد الألماني (آيزر) بوجه خاص بوصفه أداة تأويلية تبرر قابلية النص الواحد لتعدد القراءات، وفق تعدد زوايا النظر للنص (نقد استجابة القاريء / فعل القراءة /).
في أثناء مقاربته للنص عبر تأويلية الفيلسوف الفرنسي بول ريكور يستعمل “دون إهده” وقائع الحقل الجغرافي ومفاهيمه، ومن خلال تحليل موضوعة الخريطة وتحركها في واقع الملاحة البحرية على سبيل المثال يستنبط منظورين اثنين : أحدهما علوي يتم وفقه رسم الخريطة من مشهد علوي سكوني يرتفع فوق الأرض ويعين معالمها، والمنظور الآخر جانبي، هو الفاعل في واقع الملاحة، حيث يتخذ الملاح موقعه من على ظهر مركب، ويتعامل مع معالم الأرض وفق زاوية نظر أفقية متحركة. الخريطة تقدم صورا ساكنة، والملاح من على ظهر المركب يشاهد حركة، ويدخل في نظام الحركة، بحيث يمكن مشاهدة الجزر الساكنة تتحرك في الوقت نفسه الذي يتحرك فيه الملاح نحوها، المنظور الجانبي إذن يندغم في التجربة، والمنظور العلوي متعالٍ عليها، وبالتالي لا تنطبق مقاييس الخريطة على واقع الأرض. ” هكذا من قراءة الخريطة إلى العثور على موقع ذي منظور جانبي على متن السفينة لا بد من إضافة فعل تأويلي معين، فعل تحويل المنظور من العلوي إلى الجانبي ” (الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور / المركز الثقافي العربي / 1999/ص175)
ينسحب هذا الكلام – من وجهة نظري – على المشهد النقدي السعودي، وهو مشهد يمر بحالة مخاض إيجابية، رغم كل منظورات السلب التي تحاكمه بتشاؤمية كبيرة. ولعل مرد هذه التشاؤمية المفرطة راجع إلى زاوية نظر علوية تراقب المشهد في حالة سكونية، تصفه المنجز النقدي في صورة جزر منعزلة بعضها عن بعض، بينما تبدو زاوية النظر الجانبية التي تراقب النتاج النقدي في تعالقاته وفي صميم حركته، في محاولة للكشف عن آليات تلك الحركة في سبيل مراجعتها، هي الأكثر جدوى في محاكمة راهننا النقدي.
ووفق هذا المنظور الجانبي يمكن مقارنة راهن النشاط النقدي بتاريخه القريب، نظرا لحداثة التجربة النقدية السعودية بصفة عامة، فما يمكن عده ذروة النشاط النقدي كان مصاحبا لموجة الحداثة الشعرية في الثمانينات، وهو على زخمه كان يدور في إطار حلقة مفرغة تحركها مقاربات سطحية للحداثة قوامها المغالطة والتعصب، حتى أنه لم يلامس عمق الحداثة الفلسفي إلا في السنوات الأخيرة عبر المقاربات المعدودة لكوادر أكاديمية في حقل النقد، وفيها تم تناول الحداثة في بعديها الفلسفيين التاريخي الذي يناقشها وفقا لأصولها الغربية، والتزامني في محاولة لمقاربة حداثية لراهن الثقافة العربية.
ولعل من الطريف أن العامل الأكاديمي الذي لا يخلو من ميزة الموثوقية، التي يكتسبها من العمق عبر الطابع التخصصي، هو نفسه يمثل حجر عثرة في وجه المرونة والانفتاح، ومن ثم يقف عائقا دون نشاط وفاعلية الحراك الثقافي. وهذا هو الحاصل في نقدنا المحلي الذي لا زالت تهيمن عليه الأقلام الأكاديمية، وتخضعه لاهتمامات فردية تتبع تخصص الناقد وتخدمه دون أن تحفل كثيرا بواقع المجتمع، والتفاعل مع قضاياه، بينما تكمن فاعلية الثقافة في حراكها الاجتماعي، كونها تنبع من واقع المجتمع، وليس من موقع مثالي متعالٍ.
وفق هذه الفاعلية الاجتماعية للثقافة صنف الفيلسوف والمفكر الفرنسي (فوكو) نفسه مثقفا ، ليميز تنوع نتاجه الفكري ومرونته بالمقارنة مع نتاجه بوصفه أكاديميا، قائلا في حوار معه : ” لو أنني أردت الاقتصار على أن أكون جامعيا لكان من المنطقي بلا شك اختيار مجال، مجال واحد أكرّس له نشاطي متعهدا بإشكالية معينة ومحاولا إما استخدامها أو تعديلها في بعض النقاط ” (مسارات فلسفية / دار الحوار / 2004/ص33). وهو يرجع أهمية الثقافة إلى آلية من آليات الذهنية النقدية، أعني بها مراجعة الذات وتعديل مسارات التجربة من خلال التجريب “يبدو لي أن هذا العمل المتعلق بتعديل فكرنا الخاص وفكر الآخرين هو مبرر وجود المثقفين ” (السابق /ص33).. ووفق آلية التجريب بصفة خاصة يمكن النظر بتفاؤل لراهن الحراك النقدي، حيث تضطلع به أصوات شابة تسير بحماس لتشكيل تجربتها الخاصة. وهي في هذا المسير تجرب في مختلف الاتجاهات، وتراجع نفسها بمرونة كبيرة. وهي بذلك قابلة لتطور ناضج إذا ما تم توفير جو مثاقفة صحي، قائم على ذهنية نقدية سليمة.
المرونة والانفتاح والتجريب إذن من أهم آليات الذهنية النقدية السليمة، وهي مرتبطة بقوة بحداثة التجربة لدى الأصوات النقدية الشابة. ولعل هذا مما يؤكد قصور النظرة العلوية السكونية لراهننا النقدي، وهي نظرة تجعل حداثة الأصوات النقدية وقلة تجربتها عيبا يسم المشهد النقدي الراهن، يتم عبره إحباط هذا الحراك، ومن ثم تعطيل تلك الآليات التي نعول عليها في مستقبل مبهج للثقافة السعودية عامة، وليس في حقل النقد الأدبي وحده.
من هذا المنظور الجانبي يمكن مشاهدة النقد السعودي يمر بمنعطف حركي مختلف عن منعطفاته السابقة، حيث النشاط النقدي الراهن منفتح على مختلف الاتجاهات، ويمتاز بالمرونة والقابلية للتجريب. غير أن بين المنظورين السابقين : العلوي والجانبي ثغرة ينبغي ردمها ليكتمل المشهد، تلك الثغرة ألمحت لها آنفا عبر الإشارة لضرورة توفير الجو الصحي للمثاقفة، وفي هذا الجو يتم تجسير المسافة بين المثقف والأكاديمي، بحيث توفر الثقافة الأكاديمية المتخصصة أفقا يسهم بقوة وفاعلية في مراجعة وغربلة الحراك الثقافي، وهو أفق ينبغي أن يتسم بالعمق والموضوعية التي هي صلب الثقافة الأكاديمية ومرتكز موثوقيتها.